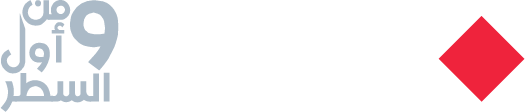إقرأ أيضاً

أطروحة كاملة، قُدمت في السبعينيات بكلية الآداب قسم التاريخ، في جامعة القاهرة، تتناول حقيقة أن رحلات العالم الآخر، الخاصة بالثقافة العربية الإسلامية، لم تتوقف على رسالة غفران المعري، ولا كيمياء السعادة لابن عربي، وأن شهرة الغفران جاءت بسبب ادعاءات اقتباس دانتي منها في الكوميديا الإلهية، وهو ما دحضته دراسات عدة، تؤكد أن الوعي الإنساني واحد، وأن لهذه الرحلة أصول أبعد من ذلك: هناك كتاب سرياني، وهناك رحلة مشابهة في ثقافة الصينين والهنود الحمر الخ، ولكن الاكتشاف الثوري الذي جاءت به الأطروحة، التي عرضها عليّ الصديق باسم عبد الحميد، صاحب صفحة الأزمنة الحديثة للكتب المستعملة، والتي وجدها في يوم غائم، ضمن كتب عند بائعين في سوق سينما ديانا، وكانت نسخة مُتربة؛ كتب عليها أنها تأليف وبحث عبد الحليم الجندي، بدون عنوان، لضياع الغلاف الخارجي، أن هناك رحلة أخرى تمت في العصور الوسيطة الإسلامية، وتحديدًا وقت دولة المماليك، وقام بها فقيه ومؤرخ مصري اسمه ناصر الدين عباس بن أحمد بن دمنة، يعُتقد أن أصوله من الهند المغولية، وأن اسم دمنة هذا يعود إلى الكتاب الشهير؛ كليلة ودمنة، ولعل جده الأول جاء مع المماليك البحرية التترية الشهيرة في نهايات الدولة الأيوبية أو بدايات دولة المماليك. كتب هذا الفقيه كتابه الموجود في الأطروحة، واسمها رحلات دمنة بلا كليلة للآخر في ليلتين وليلة، والاسم الذي يحوي سجعًا رخيصًا، كان من المهم فهمه في إطار موضوع الكتاب نفسه، والذي هو توثيق لرحلة قام بها هذا المؤرخ والفقيه إلى العالم الآخر في فترة لا تزيد عن ثلاث ليالي. حسب كلام صاحب الأطروحة المجهول، الذي بحثنا عنه بلا جدوى، في متاهات الأسماء المتشابهة بالمدينة، ذكر ناصر الدين دمنة-اختصرت الاسم لأن دمنة هذا كان اسمه طوال الكتاب، بدون الديباجة الطويلة-أنه رأى أقسام الآخرة الثلاث؛ النار والأعراف والجنة، في ثلاث ليال، وأن ذلك لأن مكانته لا تضاهي مكانة سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي رأى كل ذلك في ليلة واحدة هي ليلة الاسراء والمعراج. يستطرد بعدها دمنة في شرح كيفية عمل الزمن في الآخرة، وأنت وحدة تبدأ عند الله، مثل كل شيء، وتنتهي به، فاليوم عند الله بألف سنة كما ذُكر في كتاب الله، ثم يكون اليوم عند سيد الملائكة جبريل عليه السلام بألفي عام، وصولاً إلى أقل وحدة لليوم، والتي هي الوحدة البشرية العادية، والتي يكون فيها اليوم يومًا من أربع وعشرين ساعة، وأن المكانة الروحية للبعض تؤهله لرؤية الآخرة في عشرين ليلة، أو مائتي ليلة، ولكن لن يرقى أحد لأن يراها في ليلة واحدة مثل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
نجح دمنة في رؤية الآخرة في ثلاث ليال، وكانت المقدمة التي وضعها لاحقًا، والتي تشرح سبب رؤيته لها دونًا عن غيره، تضع شروطًا معقدة وغير واضحة، مكونة من دوائر من الأذكار، تُقرأ بصفة بعينها في ليلة الاسراء والمعراج من كل عام، وعلى مدى سبعة أعوام-العدد سبعة المقدس في الإسلام-ليحدث بعدها أن ينام مؤدي الأذكار ويرتحل أثناء الحلم. يكون الحلم عبارة عن خروج للروح وعروج لها في مضارب الخيال الحر، ليكون هو السيد المطاع وقتها، يرقص كما يريد، ويحلق بعنفوان والبصر حديد، وقد حدث وحلم دمنة حلمه، الذي كتب بعده الكتاب ليصف رحلته بالتفصيل. علاوة على دوائر الأذكار هذه، هناك تأكيد على أن هذا الأمر منحة من الله، يؤتيها من يشاء وأن شرط الأذكار ليس ضمانة كافية- ولعل في ذلك رغبة من دمنة في وضع الجميع بالواقع، حتى لا يكون هناك تخيل بأن كل شيء متعلق بالدوائر المعقدة، ولا أريد التفكير في أنه غرور شخص شاهد أغرب القصص-كما أنه نام لثلاث ليال، كما ذكر، وهو ما يعزز المعجزة، رغم أن ذلك يعني غيبوبة في عالمنا المعاصر.
في قسم جهنم الذي بدأ به الكتاب، وصف أن لجهنم سبعة أبواب تفضي إلى سبع طبقات، وأن كل طبقة واحدة كبيرة تحوي سبع طبقات فرعية، تتفرع كل واحدة منها لسبع طبقات أخرى، حتى تصل إلى أن يتفرع من السبعة سبعة طبقات أخرج ليكون المجموع تسع وأربعين طبقة؛ يكونون جميعًا سبع في سبع: وهكذا في الأعراف والجنة، وهي نظرة تدحض آخرة دانتي التاسوعية، والتي اختصرت الخطايا في تسع فقط، بينما آخرة دمنة أكثر تعقيدًا من ذلك، ومناسبة لغرابة الأفعال البشرية السيئة، وترابطها بشكل صعب. لم يطلع دمنة، والذي صحبه رفيق بين هذه الطبقات، ذكر أنه رجل صالح صالح اسمه المعتصم بربه محمد بن حسن، وترجم له بأنه صاحب موسوعات كبيرة في تفسير القرآن، وأنه قضى حياته في البحث عن اسم الله الأعظم الذي إذا دُعى به أجاب وتفتح به مغاليق السماوات والأرض، حتى عرفه قبل وفاته، ولم يستطع كتابته لحكمة الله في أن يظل الاسم مخفيًا- والرفقة هنا من تقاليد جولات الآخرة كما حدث للجميع، ولها مراتب، فسيدنا جبريل مثلاً، كان رفيق النبي لأنه الرفيق الأعلى مكانة في العالم الثاني لسيد الخلق في العالم الأول-لم يطلع مع صاحبه على كل طبقات الجحيم، حيث اكتشف أن كثيرًا منها استعصى عليهم دخوله لشدة العذاب فيها، واكتفى بوصف الدخان الأسود والظلام الشديد والصراخ الذي يشبه عصف الريح، كما وصف الطرق الخاصة بالمعذبين من المسيحيين، والتي تحمل صلبانًا سوداء كبيرة، وطرق اليهود، وكان أغرب ما ذكره، رغم ابتعاد الكتاب عن زمننا، وهو ما لفت الباحث صاحبنا، أنه رأى بعضًا من اليهود يرتدون ثيابًا خضراء زيتية، تماثل في أوصافها ملابس جنود الاحتلال، وأنه عندما سأل رفيقه المعتصم بربه عن عذابهم قال:
-العلم عند الله، فهؤلاء لم ترد لي الخاطرة لأعرف أمرهم.
لم يتوقف الباحث عند هذه النقطة طويلاً، ولكنه ذكر الرعب والكآبة المصاحبين لأوصاف دمنة، بما يفوق أوصاف دانتي نفسه، والفتحات المظلمة التي كانت تفضي إلى لا شيء، وتكوين الجحيم، الذي هو ظلام محقق، تضيئه النار، وأن جهنم وحدها كون خاص، يقع أسفل الأرض- ليس في الطبقات السفلى منها ولكن أسفلها بمنظور جغرافي، في اللامكان بالفضاء- بينما تقع الجنة بالأعلى، وصولاً إلى الكون المضيء الذي ان يمسسه ظلام، وأن هذه الفتحات هي بوابات جهنم المذكورة، حيث تصل بالإنسان إلى مكان يكون الزمن فيه مختلفًا عن أي زمن آخر، ولا يخضع لنفس القانون. الهوس البشري الطبيعي بالعذاب والغموض والظلام والقصص السوداء، جعل أغلب الأطروحة تكرس حول جهنم نفسها، ولكن جزءًا كبيرًا فقُد ولم يتبين منه سوى وصفها بجبل كبير، يشبه جبل المطهر عند دانتي، يفصل بين كوني النور والظلام، ويكون فيه الزمن طويلاً جدًا، بالمقارنة مع زمن جهنم، الأقصر منه إلى حد ما- يذكر دمنة أن المعتصم بربه ذكر أن قصر زمن جهنم من رحمة الله التي وسعت كل شيء- ويشعر من فيه بحركة قطرة الماء وهي تنزل من ورقة شجر، بطريقة تدعوا إلى الملل، حيث تأخذ ما يقارب الساعة إذا صح استخدام هذه الوحدة، وهو ما يجعل الانتظار العقاب الأكثر صعوبة في الأعراف، فلم يكن فيها عذاب بالمناسبة مثل مطهر دانتي، لأن العذابات المذكورة في المطهر عنده رآها دمنة في طبقات الجحيم الأولى الخفيفة، وأكد معها أنه لا عذاب في الأعراف سوى الانتظار، بينما كان القسم الخاص بالجنة والفردوس يصف عدة طبقات تصل إلى تسع وأربعين طبقة أيضًا، لها سبعة أبواب رئيسية، وكل باب يفضي إلى كونه الخاص، كلها لا ليل فيها ولا ظلام، والطبقة الوحيدة التي ترى الليل هي أولى طبقات الجنة، وخاصة من أخرجتهم رحمة الله من العذاب بدون عمل صالح واحد حتى، ويرون فيها أمسيات حمراء غريبة، مصحوبة بطلبات أهل الجحيم المجاور ببعض الطعام، ولكنها تختفي مع الريح ويشتتها التناقض الذي يحدث في الزمن بين الطبقتين. كانت أوصاف دمنة الشعرية تزداد كلما تحدث عن العذاب، وهو ما يقارنه الباحث بما فعله دانتي وأبو العلاء، حيث يؤكد أن هناك هوس إنساني خفي بالهزيمة والضياع والتشتت والفناء مع الفراق والوداع، وهو ما يجعله مصرًا على الحزن ولو كان يرى شموس الأعراف الأربع التي ذكر أنها تشبه شموس العالم، ولكنها تسبب حرارة صعبة يتعرق بها سكان الأعراف بدون توقف، ويغرق بعضهم في عرقه أو يكاد كلما كانت ذنوبه تفوق أعماله، ولكن أعماله الصالحة قوية ومركزة إلى الحد الذي وضعه في الأعراف وأزاحته عن كون الرعب.
على أية حال، لم يستطع دمنة وصف الجنة كما رآها، بسبب حالة النشوة التي كانت تصيبه كلما سمع لحنًا خالدًا يتردد بين الأشجار، مع موسيقي وصفها بدقة- وكان على علم بالموسيقى وطبائعها- وكانت تشبه في وصفها نوتات كتبها بيتهوفن لاحقًا، كما وجد الباحث بشكل شخصي، وخاصة السيمفونية السادسة المشهورة المعروفة بالسيمفونية الرعوية، وهو ما جعله يضع أسئلة حول مدى أصالة إبداع الانسان على مر العصور، وكيف أنه مرآة عاكسة لابداع الله الذي يتحدى الأزمنة، وأن الموهبة ما هي إلا تلقي الوحي أيًا كان نوعه، كلمات أو موسيقى أو صور تتراءى في هدأة الخيال، كما وصف الثياب النظيفة الخضراء والبيضاء، ورقصات قراء القرآن في دوائر، والوردة الكونية العظمية التي وصفها دانتي أيضًا، والتي ذكرت في القرآن بأنها وردة كالدهان، حتى انتهى الكتاب بدعاء باك طويل من دمنة، ووصفه بأنه دعاء تلقاه بالحرف من المعتصم بربه، وذكر أن بداخله اسم الله الأعظم، بدون تعيين؛ اكتفيت بكهيعص احتميت بحمعسق قوله الحق وله الملك سلام قولاً من رب رحيم احون ق ادم حم هاء آمين، وهو آخر الدعاء الطويل، والذي يحوي الخلاصة كما ذكر دمنة.
ما تنتهي حول الأطروحة، والتي ذكرها الباحث، بأن وجود رؤى مختلفة للآخرة تتعد بتعدد البشر، وأن هناك أجسام أساسية لها، ولكن تختلف الرؤى بمقدار قدرة الانسان على التخيل، ولكن ما توقف عليه طويلاً، أوصاف دمنة ليهود معذبين، يرتدون ثياب الاحتلال المعاصر، وهو ما يعني أن الزمن هكذا بلا ملكة، فمن سيكون قائدًا دمويًا لاحقًا، يعُذب في زمن دمنة الذي مر عليه ستمائة عام مثلاً، والقائد نفسه لم يكن قد جاء في زمن الباحث- حدد فيه اسمًا معينًا بناءً على الاسم الذي سمعه دمنة وذكره متعجبًا- وهو ما سبب للباحث حيرة، حيث شعر أن هذه النقطة تحديًدا هي معجزة النص الثورية، وأن فكرة أن النجوم التي نراها في صفحة الليل، ليست سوى صورة من الماضي، تؤكد أننا لسنا هنا الآن، ونحن نقرأ هذا المبحث، وأن دمنة لم يكن موجودًا بالفعل في عالمه والعالم الآخر بنفس الوقت، بل مات الأصلي الذي كان يحلم، موتًا كاملاً، وخرجت روحه، ثم عاد إلى الحياة، ولذلك لم تكن هذه غيبوبة وأفاق منها، وهو نفس ما جرى لدانتي، وهو دليل أن الاسراء والمعراج تم بالجسد والروح معًا، في معجزة خاصة بالنبي، والشيء الذي حدث، أن الروح انتقلت إلى جسد آخر موجود الآن بالآخرة، يمثل دمنة، ينتظر لحظة الاتحاد النهائي، ولذلك كتب الباحث بحيرة وإرهاق واضحين في أطروحته:
-هذا يعني أننا هنا ولسنا هنا، وأن زمننا هذا وهم. بغض النظر عن مصير الأطروحة، اهتممت بمصير الباحث نفسه، عبد الحليم الجندي، وبعد بحث شاق وبه رشاوى بأرشيف الجامعة. تبين أن هناك باحثًا بنفس الاسم، وأنه حاز الماجستير بعدها، وكان عنوانه واضحًا بالورقة القديمة، يسكن في شارع سليم بحلمية الزيتون، ولأن عمره المتوقع سيكون قد تجاوز السبعين، لم أتحلى بالتفاؤل الكافي لتوقع أنه لازال حيًا، واكتفيت بزيارة سريعة للمكان، باعتباري كاتبًا يبحث عن قصة أو موثق يبحث عن موضوع يكاد ينسى، ولم أجده بالطبع هناك، بل وجدت مكانه مكتب محاماة، ولأنني لا أملك القدرة على معرفة سيرته الخاصة بسؤال المحيطين، اكتفيت باسناد الأمر لأحد الباحثين الجادين الذين يعرفهم كريم جمال، الصديق والباحث الشهير في الموسيقى وتاريخ أم كلثوم تحديدًا، وهكذا توصلت إلى المعلومة التي توقعتها بخاطرة سريعة، يمكن أن تكون وحيًا كما ذكر دمنة في كتابه المفقود، وهي أن عبد الحليم الجندي هذا قد اختفت سيرته تمامًا منذ الثمانينات، بعد البحث، وأنه ظهر في مقال وحيد بالأهرام، كتب فيه شيء عن التصدي الواجب لأي كاتب عربي معاصر بكتابة رحلة للآخرة كما فعل الأوائل، وأنه بصدد هذا المشروع الشخصي، ويعد له الأبحاث الكافية. هناك عدة احتمالات هنا: اما أنه صار موظف عادي، في مكان ما، ويحيا حياته باسم آخر أو خارج الاطار الرسمي- وهذا صعب في بلد توثق كل شيء منذ أيام الفراعنة- وترك الموضوع بعد فورة الشباب، أو هاجر إلى بلد أوروبي ليدرس في الجامعة عن أطروحته، وأعتقد أن هذا سيكون ختامًا سعيدًا للقصة، لأنهم يهتمون هناك بهذه الأمور، لعل الكتاب في مكتبة أوكسفورد الخاصة، أو الاحتمال الثالث الأكثر غرابة، والمناسب لأن يكون قصة مثيرة؛ أنه حاول بطريقة دمنة، ولكنه اختفى أو مات للدقة، ولم يعد أبدًا من رحلته ليخبرنا عما رأى، وهي احتمالات كلها يمكن تصديقها اذا صدقنا أن هناك عدة أزمنة، وأن الدنيا والآخرة متلازمين، وأننا هنا وهناك، ورغم قلقي من النتيجة، أنتظر نتيجة البحث في سجلات الوفاة للتأكد من الموضوع، مع رغبة أصيلة في التلذذ باكتشاف الظلام الذي يختبيء خلف هذه الحقيقة، أو أن عبد الحليم الجندي هذا وجد نفسه أثناء الرحلة، ولم يستطع قبول فكرة العودة.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.