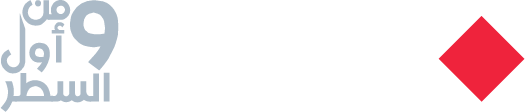إقرأ أيضاً


المشهد الاول؛ المكان، منزل أسرة عربية متوسط الرفاه، في ضاحية من ضواحي عاصمة عربية، في ربيع سنة من السنوات العشر الأولى من الألفية الحالية. “ليش المودم مش ضاوي؟؟”، يرد الأب: الكهرباء مقطوعة! يعاجله الابن الفتي: يابا!! اقطع عنا الاوكسجين ولا تقطع النت!
المشهد الثاني: المكان كابيتول هيل، 10 نيسان 2018، مارك زوكربرغ مؤسس فيسبوك “الآن ميتا” بوجه أحمر وأيدي متعرقة، يجيب استفسارات لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للتجارة والعلوم والنقل.
المشهد الثالث: غرفة اجتماعات في إدارة ميتا في مينلو بارك في كاليفورنيا، أواخر الصيف من عام 2021، رجل أوروبي ببزة فاخرة: “ميتا العالم الرقمي، سيصبح العالم الحقيقي. إذا لم تكن في ميتا؛ فأنت غير موجود”. يهمس موظف برتبة بسيطة من أصول أفريقية لزميلته الآسيوية بابتسامة ساخرة: قريتنا مدلابونغولو في إقليم إهلانزيني لم تصلها الكهرباء بعد، الأستاذ محى وجود قبيلتي من العالم لأنهم محرومون من الوجود الميتاوي!
المشهد الأخير: المكان، مستشفى في غزة، اليوم 5 نوڤمبر ٢٠٢٣، في المشهد طفلة تبحث بين الجثث عن شيء يشبه شيئاً من جسد اختها، آخر الباقين من عائلتها التي شطبت من السجلات المدنية ومحيت “فعلياً” من العالم. المشهد فيديو في منصة من منصات التواصل الاجتماعي داخل هاتف نقال، يختفي وجه الفتاة المحتقن بالدموع والغضب والخوف بشاشة سوداء تقول: this is fake news.
لم يعد الوصول إلى الإنترنت رفاهية محتكرة على القلة، بل أصبح أحد أهم أدوات الإنسان، أداةً تضاهي الحاجة إليها الحاجة إلى أي من الضرورات الحياتية على هرم ماسلو. وربما تكون هذه الثورة المعلوماتية تجلٍّ حقيقي لفكرة أسَّست لها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مفادها أن الحق في التعبير والرأي حق لصيق بالحق في الحياة. أما تجليها الاقتصادي-الاجتماعي يتلخص في أن عديد معايير التطور الاقتصادي والحريات الاقتصادية اليوم تعتمد الوصول للمعلومات والمعلوماتية كأحد العوامل التي تحكم على مستوى البلاد أو المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، كمؤشر التنمية العالمية للبنك الدولي، مؤشر أهداف التنمية المستدامة، SDGs، والمؤشرات الأكثر تخصصية كمؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI، ومؤشر الجاهزية الشبيكة NRI الذي يرصده المنتدى الاقتصادي العالمي. وتصدت العديد من المؤسسات للدفاع عن الحق في الوصول لإنترنت آمن ودون قيود مثل Internet Society، و Access Now وغيرها الكثير.
هذا التحوُّل المهم في المعايير والمثل العليا، وجد صداه في ثقافات الأجيال أيضاً، مثلاً عندما تقول لأحد من أبناء جيلي كلمة بريد، يتبادر لذهنه مباشرة الصندوق الحديدي المعهود في مكتب البريد المحلي في بلادنا، أو على مدخل المنزل في الدول الأوروبية، الذي يسقط بداخله ساعي البريد؛ -وهو شخص حي من لحم ودم يتقاضى راتباً من الدولة- يسقط مغلفات الرسائل الموسومة بطوابع بريدية وأسماء المرسلين والمستقبلين للبريد. هذه هي الصورة الأصلية في أذهاننا، والبريد الإلكتروني بالنسبة لنا هو النسخة الرقمية من هذا البريد الأصلي. بينما يرى أبناء جيل زد وجيل ألفا وما وراءهما، البريد الإلكتروني في العالم الافتراضي أصلاً والنسخة الواقعية نموذج ملموس للأصل الإلكتروني. قد لا تبدو المسألة معقدة كثيراً، لكن هاتان الرؤيتان المتعاكستان اللتان تصلان لنتيجة واحدة في التطبيق نموذجٌ على اختلاف طريقة التفكير بين جيلنا “المهاجر إلى الرقمية” وجيل “الرقميين الأصليين”. رسمت كذلك وسائل التواصل الاجتماعي تضاريس جديدة عظمت وأحياناً قلصت فجوة الأجيال هذه، فتجد الشباب يهربون من منصات الشيوخ، والڤلوجرز؛ أو المدونين بالفيديو ينزاحون نحو منصات تختلف عن تلك التي يفضلها الكُتاب والمحللون والسياسيون، وفي ذات الوقت تجد الحجات والعواجيز الأميات يطلبن من أحفادهن وكناينهن أن “ينزلو لهم واطس!”.
المهم، أن كل القاطنين في الجغرافيات الرقمية المختلفة، أصبحوا متفقين على أن “النت أهم شي”. بالتأكيد سيكون صعباً على أيِّنا أن يعود إلى قوقعته المحلية المحدودة بعد أن مارس الحياة الرقمية في عالم رحبٍ ملون. هذا “النت” خير وعمَّ على الجميع. وكأيِّ خيرٍ يعمّ، ويمكن في ذات الوقت استخدامه للإضرار بالغير، يحتاج إلى حوكمة من نوع ما، لذلك تصدّت المؤسسات التشريعية فسنت قوانين وضوابط، تحكم استخدام العامَّة لهذه الأدوات، بشكل يحمي الحريات، ويمنع تغول الأحرار على حقوق الأحرار الآخرين المعنوية والمادية والأدبية. حلو كثير! بل ضروري! طيب لماذا لم نجد تنظيماً حقيقياً لعمل مقدمي الخدمات، لا أعني هنا شركات ضخ الخدمة في الأسلاك والأثير، بل منصات التواصل، التي تضع لمجتمعاها معاييره وضوابطه التي ترسم الحدود بين المباح والمحرم تحت طائلة تجميد الحسابات؟ مشهد زوكربرغ شفى غليل العديدين من أنصار الإنضباطية والمعيارية، وعزز لديهم قناعة بوجود رادع ما يسيطر على هذا المارد الأزرق. وساهمت العبارات الرنانة التي أصمَّتنا بها دول “الشمال” بنبرة استعلائية صارمة، عن حرية التعبير والرأي، وانتقاداتها الحادة في المحافل الدولية لدول “الجنوب” القامعة للآراء المكممة للأصوات، ساهمت في تعزيز صورة وردية حضارية لدول ومؤسسات تقدس الحريات. ما جعلنا نسقط من علياء القيم إلى صخرة الواقع عندما تفاجأنا بانقلاب الحضارية الوردية على كل ما نادت به، عندما استخدمت المقاومة المشروعة ذات أدواتهم العالمية في فضح انتهاكات أحد اعضاء نادي النخب تجاه “اللانخب”. ونتساءل هنا، هل المعايير تطبق على الجميع بعدالة؟ أم أن هناك “ناس وناس!”؟ ويبدو أن الأخيرة هي الأقرب للواقع. لعبة التعريفات التي خرجت علينا بعد أحداث ١١ سبتمبر، مهدت الطريق لوضع قواعد الـ”ناس وناس”، مُسِخت كل حركات المقاومة إلى حركات إرهابية، واتخذ المجتمع الاجتماعي الأبيض من مؤسسات إعلامية بيضاء مرجعية محتكرة لتقييم ما هو حقيقي وما هو أنباء كاذبة، وصار كل خطاب أسمر خطاب كراهية، وكل ما دونه خطاب مشروع. حرب التعريفات التي وجدت في الرعب من داعش وما شابهها ذريعة لتمحيصٍ أكثر قسوة، وانتقائية وتجبُّرٍ على من يشبهوننا. شكل الرقابة التي مارستها مؤخراً منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى العربي المتعاطف مع الفلسطينيين، وما رشح عنها من “الحظر الظلي” ثابر على تقليل مدى وصول المحتوى الفلسطيني للعالم، وصولاً إلى حذف المنشورات التي تذكر فلسطين أو وصف الحسابات المؤيدة لفلسطين بـ “الإرهابية”! هذه الرقابة ليست مجرد حذف للمحتوى، بل هي تكميم للأفواه ومحو للهوية. من الناحية النفسية للأفراد المتعاملين مع المنصات، سواء كمتلقين للمحتوى أو منتجين له، تُوَلِّد هذه القيود شعوراً بالعزلة والإحباط وتقوض الثقة في المنصات الرقمية كمنابر حرة للتعبير، مضيفةً فصلا ًجديداً إلى مسلسل الإقصاء والتهميش لقضايا الجنوب العالمي عبر عقود. وعلى المستوى الأخلاقي الفلسفي، تطرح هذه الممارسات تساؤلات حول مفهوم الحرية والمسؤولية الأخلاقية لهذه المنصات في تشكيل الرأي العام. عند الحديث عن العدالة في تمثيل الأحداث، نجد أن السردية التي تهيمن على وسائل التواصل الاجتماعي غالباً ما تكون منحازة. يتجسد هذا الانحياز في تمثيل مشوه للواقع يؤثر على الفهم العام للقضايا الجوهرية ويعمق الفجوة بين الشعوب المتأثرة أصلاً بصور نمطية غير سوية عن الآخر.
يطرح كل هذا جدلاً حول ممارسات شركات التكنولوجيا ويثير تساؤلات جدية حول الدور الأخلاقي والقانوني لهذه المنصات. من المنطقي والأخلاقي أن الواجب يحتم على هذه الشركات مراعاة الحق في حرية التعبير والتوازن في تقديم الأحداث. ومن المفترض أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي نموذجٌ لضمانات تحقيق هذا التوازن. لكن الموضوع أكبر من قانون دولة أو اتحاد -على اتساع رقعة تطبيقه جغرافياً وموضوعياً- لأنه سيبقى دون مستوى القدرة على إدارة ما يشبه مشاعاً دولياً، تختلف مشارب وثقافات المتعاطين فيه، ولا يمكن لقيم مسيّسة، استبقت بتعريفات غير متوازنة، تحمي حقوق فئات على حساب فئات أخرى؛ لا يمكن ولا يستوي لها أن تتحكم بشكل محتكر بتحديد المباح والممنوع. يبقى السؤال المُلِحّ: هل يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تجاوز هذا التحدي وتحقيق توازن بين الحق في الأمان الرقمي وحرية التعبير؟ أو ربما، هل تريد ذلك؟؟ لنتفق أنه لا بد من توفير منبر حر ونزيه يمكّن الأصوات المهمشة من التعبير عن وجهات نظرها دون خوف من الرقابة أو التكميم، لتحقيق مجتمع رقمي أكثر عدالة وتمثيلاً للجميع. يتطلب تحقيق هذا التوازن مجهوداً جمعياً مستنداً إلى القيم الإنسانية التي اتفقت عليها الأمم المتمدنة، بشكل يضمن شمول الجميع في مظلة الحماية والحرية في آن معاً؛ للمستخدمين، النشطاء، المجتمع المدني والمنظمات الدولية، للرأي والرأي الآخر. يجب أن يكون هناك حوارٌ مستمر يتناول كيفية تمكين الأصوات المهمشة وضمان تمثيلها بشكل عادل. وبناءُ وعي المستهلكين للمحتوى الرقمي، تمكينهم من تمييز الغث من السمين والحقيقي من الزائف، مع إتاحة معلومات واقعية دقيقة، يستطيعون الرجوع إليها لإجراء فحوصات الكذب بأنفسهم، دون الحاجة لمؤسسات بأسماء رنانة، وسمعة وسخة، تقرر لهم مسبقاً ما هو صالح أو غير صالح للاستهلاك، وتمارس عليهم دوراً أبوياً عفى عليه الزمن. يجب أن تكون هذه المنظومة ضامناً للحق في الوصول لمعلومات حقيقية، وموصلاً جيداً لأصوات المهمشين بالذات. وهذا لن يتحقق بدون جهد أممي وضغط من دول الجنوب التي يقع ناسها وقضاياها في الأغلب الأعم، ضحية لتجبُّرِ المؤسسات والأنظمة المعلوماتية المنحازة.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.