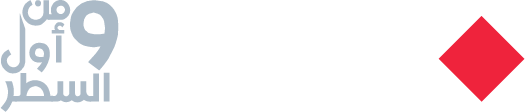إقرأ أيضاً


بعيداً عن الحروب المباشرة والسبطانة للسبطانة، تشتعل في العالم وهوامشه حروب جانبية لا تهدأ، وخاصة معارك وحروب الرموز و”اللوغوات” والهويات الاستهلاكية إن جاز المصطلح، كوكا كولا، المطرقة والمنجل، النسر الأمريكي، الكنغر الأسترالي، تشي غيفارا، عروق نبتة الحشيش، والجينز!
ولعل الجينز هو أكثرهم إرباكاً لعلماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوجيا معاً، فهو حالة نادرة من المرموز الضامّ، والذي يفتح يديه على اتساعهما ليحضن البشر رأسياً/ طبقياً، وأفقياً/ يمين ويسار.
يأتي جذر كلمة جينز من بحارة جنوة الطليان Gênes الذين كانوا يلبسون ثياباً قطنية خشنة ومقاومة ومتجاوزة في حينها، أما المصطلح الثاني “دِنيم” فمن جنوب فرنسا، وهو لفظ مشتق من نسيجٍ قطني طويل يسمى “Serge de Nîmes”، تم نسجه لأول مرة في نيم، فرنسا ويُعتقد أن الجنود الأمريكيين أخذوه معهم بعد عودتهم من الحرب في الأربعينيات.
البداية الحقيقية للجينز كانت عام 1873، حينما قام خياط من ولاية نيفادا يُدعى جاكوب ديفيس بتصنيع سراويل باستخدام قماش البطّ المقاوم، وشارك رجل الأعمال ليفي شتراوس ليسجلا براءة اختراع، حيث أضافاً أزرار النحاس على المناطق الضعيفة ليكون أكثر احتمالاً وصبغوه بالأزرق. وبحلول تسعينيات القرن التاسع عشر، كانت شركة Levi Strauss & Co. قد أهدت الرأسمالية البنطال الأمتن في التاريخ Levi’s 501 وفوراً أخذ هذه الأقمشة شديدة التحمل مالكو العبيد لإكساء عمالهم الميدانيين المستعبدين؛ في الغرب، بدأ عمال المناجم وغيرهم من العمال في ارتداء هذا النوع الجديد والمتين.
الجينز يذهب عكس ثقافة الاستهلاك الأمريكية إذ لا يهترئ ولا يبلى، وكلما تمزّق أو بهت لونه كلما كان مقبولاً، لكن أمريكا كعادتها، فهمت فوراً أنه منتجٌ لا يمكن مقاومته، فوظفته أيما توظيف كدلالة أخرى تضاف إلى ملامحها، وعاملته معاملة البطل القومي و”الجاسوس الحصيف” الذي يغزو الطبقات والمجتمعات واليمين واليسار ولا يبقي ولا يذر!
دلالة مشوشة انتقلت من العبيد وعمال المناجم بلمح البصر إلى فكرة الحرية والقوة، فارتداه أساطير رعاة البقر، وعمّ المدن الكبرى كما دخل صلات السينما من بابها الكبير مع مارلون براندو في فيلم The Wild One عام 1953، حيث ارتداه كزعيم عصابة للدراجات كما ارتداه جيمس دين “في متمرد بلا سبب”، ليتحول منذ ذلك الحين إلى رمز كبير للتمرد والانفلات من ربقة المجتمع.
على الرغم من أن معظم الناس اليوم لا يربطون الجينز الأزرق بالنضال من أجل حرية السود، إلا أنه كان حاضراً بقوة في حركات الفصل العنصري، ودعنا نتذكر صورة مارتن لوثر كينغ جونيور ورالف أبيرناثي وهما يسيران في برمنغهام، ألاباما عام 1963 في مظاهرة ضد الفصل العنصري وكانا يرتديان الجينز. هذا عمّم مفهوم الجينز للحريات في أمريكا وخارجها، فأصبح ملازماً للبارزين، يرتدونه للإدلاء بتصريحات متحدية خاصة بهم.
مع مارلون براندو من جهة ومارتن لوثر كينغ من جهة، صار دلالةً واضحةً للمطالب المستحقة وغير المستحقة معاً. للتمرد والثورة والجنون والحمق إن شئت.
انتقل من غرب أمريكا لشرقها وللعالم، لقد أصبح الجينز رمزاً للفردية والخروج عن التيار، فأفزع المجتمع البطرياركي، مُنع في المدارس والجامعات وأماكن العمل والمطاعم والمسارح. من ينسى أغنية ميرل هاغارد المضادة للثقافة المضادة إن جاز التعبير، “Okie From Muskogee”، التي يتكلم فيها بلسان المحافظين عندما كانت القيم هي القاعدة ولم يكن “الناتئون” يجدون ترحيباً في كل مكان، حيث يشير في كلماته: كانت أمريكا ممتلئة بالوطنيين ممن لم يدخنوا الماريجوانا، أو يتعاطوا عقار إل إس دي، أو يرتدون الجينز والصنادل، أو يحرقوا بطاقات التجنيد أو يتحدوا السلطة!
احتجاجاً على حرب فيتنام وإجراءات المؤسسة بدأ طلاب الجامعات في ارتدائه أيضاً. أصبح الجينز شائعًا لا يوجد شيء يمكن أن يبطئ شعبية الجينز كما نقلت إحدى الصحف: “90٪ من الشباب الأمريكيين يرتدون الجينز في كل مكان، باستثناء السرير أو الكنيسة”. يقول بول ترينكا: “لقد كان زيّاً فردياً، يا لتناقض المعنى واللفظ! ما يزال الجينز يحمل شارة التفرد حتى لو قمت بشرائه من على الرفوف.”
ويقول ترينكا: “من المعروف أن جورج دبليو بوش وتوني بلير خرجا إلى الشارع مرتدين ملابس الجينز خلال أول اجتماع لهما في القمة لنقل عبارة، مرحبا يا رفق.. نحن مثلكم.. رجال عاديون.. لكن بالنسبة لي كانا يبدوان كأحمقين”.
تمدد الجينز على الثقافات الفرعية وأصبح رمزاً عظيماً للثقافة المضادة، الهيبيون وموسيقا البانك والجرونج والروك. والمدهش أن الطبقة العليا كانت تحبه بالتوازي، فأطلق كالفن كلاين وأرماني وشانيل وغوتشي جينزهم الخاص.
في نوفمبر 1978، بدأت شركة ليفي شتراوس وشركاه في بيع أول شحنات واسعة النطاق من الجينز خلف الستار الألماني الحديدي، حيث كانت السراويل التي كان من الصعب الحصول عليها سابقًا بمثابة علامات على المكانة والتحرر؛ واصطف سكان برلين الشرقية بفارغ الصبر لاعتراضهم. بعد سقوط جدار برلين، عندما أصبحت شركة ليفيس وغيرها من ماركات الجينز الأمريكية متاحة على نطاق واسع في الاتحاد السوفييتي، كان العديد من السوفييت سعداء. “لا يمر الإنسان بدقائق سعيدة في حياته، ولكن كل لحظة سعيدة تبقى في ذاكرته لفترة طويلة”.
في استفتاء جرى قبيل سقوط الاتحاد السوفييتي أجاب 78 بالمئة من الشعب أن أكثر سلعة يتمنونها في أسواقهم هي الجينز! وفي هذا السياق كتبت معلمة من موسكو تدعى لاريسا بوبيك إلى شركة Levi Strauss & Co. في عام 1991: “لقد حان الوقت.. إن شراء جينز Levi’s 501 هو إحدى أهم اللحظات في حياتي”.
في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2006 في بيلاروسيا، نظم النشطاء مسيرة للاحتجاج على ما وصفوه بالتصويت الزائف لدعم حكومة استبدادية. قام أحد المتظاهرين بربط قميص من الجينز بعصا، مما أدى إلى إنشاء علم مؤقت وأدى إلى ظهور الاسم النهائي للحركة: “ثورة الجينز”.
في تجربة غريبة، ارتدى جوش لي، طالب علم الأحياء الدقيقة في جامعة ألبرتا، نفس بنطال الجينز الخام لمدة 15 شهراً دون غسله، اختبر محتواه من البكتيريا قبل ارتدائه كما قام باختبارها مرة أخرى كل أسبوعين من غسلها، في نهاية التجربة، وجد أن المحتوى البكتيري متماثل إلى حدٍّ كبير! قالت راشيل ماكوين، أستاذة علوم النسيج، التي عملت مع لو في التجربة: “يظهر هذا، أن نمو البكتيريا لا يكون أعلى إذا لم يتم غسل الجينز بانتظام ويبدو أن القماش يتمتع بقدرة غير مفسرة على البقاء نظيفاً”.
تقول صوفي وود: “أزعم أن الجينز هو أول الملابس ما بعد السيميائية، نقيض الهوية بمعنى أنها لا تشير إلى أي شيء آخر غير طبيعتها الخاصة”. لكنه بشكل او بآخر يتحدى الترتيب الهرمي لاحترام المجتمع.
من جهتي أعتقد أنه يريد أن يكون مريحاً دون ادعاءات البدلات الأنيقة، ويهدم تفوق الغرب المتحضر، الغرب الذي وصفه جيرارد مليز بأنه “مارس عمليات القتل الطائش والعبثي في خنادق الحرب العالمية الأولى”، على الأقل يريد أن يسكت أي تأكيد بسيط على أخلاق زعماء الغرب. إنه للرجال “الحائضين” والخائفين والسادة والأخلاقيين والنكرات مثله مثل الابتهال الديني عتد المخاطر. وعلى الرغم من ميل الأنثروبولوجيا للتبرؤ من دراسة الثقافة في حد ذاتها، وتشريحها كثقافات مترابطة ومتجانسة. بوصفها غير معيارية، لكنني أميل إلى أن الجينز ثقافة مستقلة وجامعة معاً، متبنياً قول جيرتز: “ما هي الثقافة إذا لم تكن إجماعا؟”.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.