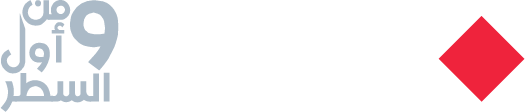إقرأ أيضاً

لدى المصريين تصميم خاص للمقابر يتضمّن بناء غرفة مُلحقة بالقبر يستخدمها أقرباء المتوفّى كإستراحة أثناء زياراتهم في المناسبات الخاصة والدينية، ولكن هذه الغرف تحوّلت مع الزمن إلى مساكن لمئات آلاف وربّما ملايين من الفقراء المصريين الذين شكّلوا شريحة إجتماعية خاصّة أسمها “سكّان المقابر”، وهناك الكثير من التحقيقات والمقالات التي تناولت حياة هؤلاء بكل ما فيها من مظاهر الحرمان والقلق لأشخاص ينامون ويأكلون ويتزوجون وينجبون وسط حضور مادّي كثيف وملموس للموت، والتي يُشاهد فيها الأطفال وهم يركضون ويضحكون ويلعبون بين القبور في طفولة قصيرة تنتهي بخروج الصبيان للعمل في سن مبكّرة للمساعدة في تأمين بعض أساسيات الحياة لأسرتهم وتدريب البنات على أعمال المنزل إستعداداً للزواج من عريس سيكون غالباً من سكّان المقابر.
وتوضّح هذه المقابلات أن الحياة في المقابر رتيبة ويتركّز إهتمام سكانها حول موضوع واحد وهو كيفية تأمين مستلزمات الحياة لليوم التالي، وأن الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحّي تُقدّم على أضيق نطاق وكثير منها لا يتحقّق إلّا عبر مُخالفات، ولعلّ النقطة الأهم أنه من الصعب على سكّان المقابر مُغادرتها إلى أماكن أفضل نتيجة إمكانياتهم المادية الشحيحة ولذلك هناك أجيال متعاقبة لم تعرف سوى هذا النمط من الحياة وكأنها في سجن لا يمكن الخروج منه رغم أنه بدون بوابات أو حرّاس، حتى أن بعض من أجرى تحقيقات ميدانية عن سكّان المقابر تساءل: من أكثر حياةً هناك من يعيش فوق الأرض أو تحتها؟.
وأول ما يتبادر إلى الذهن عند مشاهدة تسجيل عن يوميّات سكّان المقابر في مصر هو أن حياة هؤلاء لا تختلف كثيراً عن حياة الملايين من شعوب الشرق الأوسط في هذه الأيام، ففي سوريا مثلاً تعيش أغلبية كبيرة من الشعب داخل سوريا أو في مخيمات اللجوء في يوميات تتطابق مع حياة أقرانهم من سكّان المقابر المصريين، إن كان من ناحية صعوبة تأمين ضروريّات الحياة أو شح الخدمات الأساسية أو من ناحية الحضور الكبير للموت في الحياة اليومية نتيجة سوء التغذية وضغوط الحياة وضعف الخدمات الصحية والإنفلات الأمني، وكذلك من حيث إغلاق آفاق المستقبل لصعوبة الخروج إلى مناطق أخرى في العالم تمنح فرصة لحياة أفضل.
كما لا يختلف الوضع كثيراً عن حياة من يعيش في فقر مُدقع في العراق ولبنان والسودان ودول المغرب العربي ومصر مثل سكان أحزمة الفقر المحيطة بالمدن أو ما يُسمّى العشوائيات وهي كذلك مناطق غير مُنظّمة تمّ بناؤها بدون ترخيص ويفتقر كثير منها لمُقومات الحياة الكريمة وتقلّ فيها الخصوصيّة نتيجة التزاحم وتلاصق أماكن السكن الصغيرة التي تُسمى “العشش”، كما ترتفع فيها نسبة الجريمة بسبب الفقر والجهل.
في جميع الأمثلة السابقة كان الفقر هو السبب الرئيسي في حياة البؤس، ولكن مُفردة المقبرة يمكن أن تشمل بالمعنى المجازي أي مكان تقلّ فيه أو تختفي مظاهر الحياة من حرية وحيويّة وتنوّع وألوان وأضواء وفنون، وتسيطر عليه مجموعة محدّدة من الآراء الثابتة والمسلّمات التي تتردّد يومياً في المدارس وأماكن العبادة ووسائل الإعلام، والتي لا مكان فيها للرأي الآخر ولا يتجرّأ المُختلف على التعبير عن رأيه، وفي النتيجة تتحوّل هذه الدول إلى مقبرة للأفكار الجديدة والإبداع.
ومع هذا التصنيف تتّسع المقبرة لتشمل أغلب دول الشرق الأوسط، بينها من تحكمه أنظمة دينية مثل أمارة حماس الإسلامية في غزة، حيث لن تكون الحياة التي تنتظر من يولد فيها سوى رحلة من البؤس والحرمان والقهر تترافق مع دعوات للصبر بإنتظار نصر “قريب”، وتتخلّلها كل بضعة أشهر عمليات تحرش وإفتعال معارك مع إسرائيل تنتهي بهزيمة جديدة وخيبة تُضاف إلى سلسلة طويلة من الخيبات وتؤدّي إلى زيادة معاناة سكّان القطاع في حلقة مُفرغة تسوّق لها وتشجّع عليها أبواق سياسية وإعلامية تعيش حياة طبيعية في مناطق آمنة من العالم وفي نفس الوقت تُشجّع سكان غزة على التضحية بآخر شاب من أبنائهم، والغريب أن المزاج الشعبي السائد يُصوّر هؤلاء المُزاودين كأبطال ووطنيين، بينما يُصوّر من يدعون إلى الحكمة والحفاظ على حياة أطفال وشباب غزة كخونة، وفي النتيجة تحوّلت هذه الأمارة الإسلامية إلى مقبرة حقيقية.
أما في أمارة إسلامية أخرى هي أفغانستان فقد أغلقت حركة طالبان الحاكمة كل الأبواب في وجه المرأة من العمل إلى التعليم، كما تروّج هذه الحركة إلى أن أفغانستان في حالة حرب دائمة مع بقية العالم دفاعاً عن الإسلام وفي النتيجة يعيش اليوم أكثر من 85 في المائة من السكان تحت خط الفقر بل إن كثير من الموظفين يقبض راتبه على شكل سلع عينيّة نتيجة نقص السيولة في بلد يأتي دخله الرئيسي من برامج المساعدات الدوليّة، ولكن في هذا البلد نفسه تمّ “الإحتفال” قبل بضعة أيام بإفتتاح مسجد جديد تصميمه مُشابه لمسجد قبّة الصخرة!.
وفي جمهورية إيران الإسلامية لا مجال لأي رأي آخر في الدين أو الثقافة أو المواقف السياسية أو الخيارات الإجتماعية، وعقوبة الخروج عن التوجّهات الحكومية بالغة القسوة منها تقليد تُفضّله هذه الجمهورية الإسلامية وهو إعدام معارضيها شنقاً على رافعات عالية يُمكن رؤيتها من مسافات بعيدة، كما يُمكن التذكير بعدد النساء اللاتي دفعن حياتهن في الإحتجاجات التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني قبل عام من الآن على يد شرطة الأخلاق لأنها لم تكن ترتدي حجابها بالطريقة المطلوبة مما أشعل ثورة كان شعارها “مرأة حياة حرية”.
بينما تعيش الديكتاتوريات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط على المزايدات التي تقتصر على مجال الإعلام، وعلى صناعة أعداء وهميين يحاربهم الزعيم “البطل” لتبرير إنفراده في السلطة، وتزدهر في هذه الدول الإستبدادية ثقافة التصفيق لحاكم يقود البلد من كارثة إلى أخرى وليس له من هدف سوى البقاء في السلطة، ويتعاون في سبيل ذلك مع رجال دين من “شيوخ السلطان” في كبت الحريات، ولذلك يصبح التطرّق إلى جميع المواضيع أمراً بالغ الخطورة لأنه يُعرّض صاحبه للإضطهاد والإعتقال بإتهامات مثل التطاول على “مقام الرئاسة” أو المسّ بالمقدّسات الدينية أو التشكيك بالثوابت الوطنية، ولا يكفي ذلك بل يستمر التضييق حتى على السلوك الشخصي بإتّهامات من نوع خدش الحياء العام أو الخروج على قيم المجتمع وبالنتيجة وصلت هذه البلاد إلى حالة القحط الفكري والثقافي والفني التي نشاهدها اليوم.
وقد تأكّدت خلال السنوات الأخيرة حقيقة أن هذه البلاد ليست سوى مقبرة للمواهب عندما إتّسعت موجات الهجرة واللجوء إلى دول الغرب وتمكّن الكثير من أبناء هذه المنطقة من تحقيق إنجازات كبيرة، فقبل بضعة أسابيع تم تعيين الأديب الفرنسي من أصل لبناني أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية مدى الحياة وهي واحدة من أعرق وأهم الهيئات الثقافية في فرنسا والعالم، وفي نفس الوقت نال العالم الأميركي من أصل تونسي منجي الباوندي جائزة نوبل للكيمياء وهذه مجرد أمثلة على سلسلة طويلة من نجاحات حقّقها المغتربون من أبناء الشرق الأوسط في مختلف المجالات العلمية والثقافية والسياسية والرياضية عندما وجدوا بيئة مناسبة ترعى مواهبهم بينما لم يكن ليعلم أحد بوجودهم لو بقوا في بلادهم الاصلية.
وهنا يبرز التساؤل عن السبب في إستمرار هذه الحالة فقط في مجتمعات الشرق الأوسط بينما تسير أغلب دول العالم نحو الديمقراطية والإنفتاح والإزدهار، هل هي الأنظمة الإستبدادية التي تحكم هذه المنطقة منذ عقود وتُروّج لمعاداة الديمقراطية وحريّة التعبير، أم أن المشكلة في نمط الثقافة السائدة التي ترفض التطوّر والتجديد والتأقلم مع العصر، أم في المؤسسات الدينية التي تُروّج للجهل المقدّس الذي يحول الشعب إلى كتلة بشريّة من السهل قيادتها عبر نشر مشاعر الغضب وثقافة التكفير والكراهية فيها، أم أن السبب هو نتاج لمجموع ما سبق ولا بدّ من كسر هذه الحلقة الجهنميّة حتى تتمكّن شعوب هذه المنطقة من الخروج من حياة “سكان المقابر” نحو مستقبل أفضل.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.