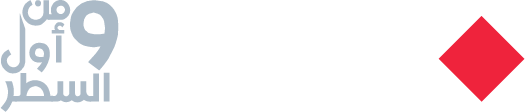إقرأ أيضاً

تابعت بالأمس الفيلم الجديد تحت الاسم القديم Little Mermaid أو الحورية الصغيرة، وهو إعادة إنتاج للفيلم الكلاسيكي المعروف من مجموعة أفلام اميرات ديزني الكرتونية بالأشخاص الحقيقيين. هنا أيريل سمراء أثيوبية الملامح، والدها يبدو إسبانياً، لها اخت آسيوية، أخت أفريقية وأخرى أوروبية وأخت هيسبانيك. أميرها الذي تلتقي أبيض البشرة، أمه إفريقية، يعيش على جزيرة ملامحها خليط من سواحل افريقيا وجزر الكاريبي، وشكل أسواقها بين الأسواق العربية والشرق أوروبية، خليط عجيب لا يشبه من بعيد القصة الأصلية التي تستند إلى روايات بحارة اليونان القديمة وأوروبيو العصور الوسطى، التي تناقلها فيما بعد بتجويد أكبر بحارة الجزر البريطانية قبالة الساحل الشمالي الغربي لأوروبا القارية. ما يجعل القصة بأصلها ووصفها بيضاء جداً! قبل سنوات، اختُتِمت سلسلة أفلام أبطال مارفيل ببطل جديد أسود البشرة متعايش مع إعاقة حركية لم تمنعه أن يحلق في السماء، يختم الفيلم الأخير بالشاب الأسمر الوسيم وهو يستلم درع كابتن أميركا من حامله الأصلي الأبيض الذي لا يقل وسامة.
الفلمان عينة من عديد الأعمال الفنية التي تتعمد إدخال شخصيات بهويات متعددة في سياق القصة التي كتبت أصلاً كعمل فني أبيض معتاد. لم يرَ المشاهد في كل هذه الخلطات الكوزموبوليتانيه أي شيء عضوي وطبيعي، ولم تظهر أي حبكة معنية بحق بجعل الآخر جزءً من السردية، ولعل أفلام زمان كانت أنجح في ذلك؛ فتجد فيلم Lethal Weapon أقل تكلفاً في إظهار الآخر كإنسان عادي، فكان روجر ميرتوغ “الذي يتقمص شخصيته الممثل القدير أسود البشرة داني غلوفر” يسعى طوال أجزاء الفيلم أن يجعل من الشرطي المتشرد السكّير مارتن ريغز “الذي يلعب شخصيته الرائع ميل غبسون” إنساناً محترماً. كل محاولات ديزني، ومارفل وغيرها من مدعي الإدماج والحضارة تبدو أشبه بـ “طبيخ الشحادين” أو كالبطانية المرقعة، ربما كفعل تكفيري أو تطهيري عن سينما لم تكن بيضاء فحسب بل، مشوِّهة لكل ما هو غير أبيض. عقود من السينما صورت الأسود كمجرم ومدمن للمخدرات، المخدرات التي يوفرها له المروج اللاتيني “فيلم Training day” نموذجاً، الصيني كفاسد “فيلم Year of the Dragon” نموذجاً، الإيطالي ربيب عصابات “فيلم العراب The Godfather” نموذج غني عن التعريف، والفيييتنامي كمتوحش “فيلم Platoon”. وأخيراً تصور المدافعين عن الحريات في البلاد التي يحاول الأمريكي “تقديمها للديمقراطية” كإرهابيين يقتلون بدم بارد
“فيلم The siege” مثال من أمثلة متعددة. من أفلام حرب فيتنام مروراً بأفلام مطاردات الشرطة والجرائم وصولاً إلى أفلام حروب الإرهاب الحضري؛ تعمدت هوليوود غسل أدمغة المشاهدين، الذين يلتصقون بالشاشة، جالسين بتأهب على حواف كراسيهم في سينما أفلام الإثارة؛ منتظرين مثلاً لحظة إنقاذ الجندي المسكين من بين أيدي السفاحين الفيتنام، بتشويه واضح ومتعمد للوعي الجمعي. ولا يبدو اهتمام المخرجين والسيناريست والمنتجين مؤخراً في محاولات إدماج الآخر اليائسة إلا استرضاءً فاشلاً تحت عنوان الصوابية السياسية.
نشأ مفهوم الصوابية السياسية في القرن العشرين منطلقاً من مراعاة تجنب اللغة التي يمكن اعتبارها تمييزية أو متحيزة، خاصةً فيما يتعلق بالعرق والجنس والجنسانية. ما بدأ في ظاهره كغاية نبيلة تتلخص في تعزيز الشمولية والحساسية تجاه المجموعات المتنوعة ترسيخاً لفكرة أن لا يشعر أحد بالإقصاء أو التهميش، سرعان تحول إلى كرت أحمر، يوصم من لا يراعي أصوله بدقة وحذر بالإقصائي والعنصري، وتحول –ما يبدو في ظاهره مبادرة طيبة- إلى قيد على حرية التعبير، وتسبب في مسخ الكثير من الأعمال الإبداعية بقيود أحالتها إلى نوع من السذاجة والخروج على التاريخ والطبيعة. وربما كما الإنسان الذي يقع أسير الإحساس بالذنب يصبح مبالغاً في إثبات البراءة، كذلك تفعل الشعوب بطريقة أو بأخرى. بين ثقل إرث الهولوكوست، ووطأة بشاعة جرائم الكوكلوكس كلان، إلى سياسة
الـ تي 4 النازية المقرفة؛ حصاد آثام، ومحاولة يائسة لإعادة اعتبار أو تبييض “white-washing” تاريخ دموي بشع، لكن “التقليد مش زي الأصلي”.
التكفير، يبدو منافقاً بشعاً إذا لم يصمم بتزاوج وطيد مع سلوكات وسياسات ذات أثر واقعي تحاول جبر الضرر وإصلاح ما يمكن إصلاحه وأكثر. بدءً باعتذارات رسمية، وصولاً إلى تعويضات مادية، و جهد حثيث لرأب الصدع المجتمعي. ننظر إلى النموذج الروندي، الذي يشي بإدراك القائمين عليه خطورة الجمر النائم تحت الرماد، مدركين أن العمل في حدود الإنشائيات والكلام لا يجدي نفعاً في سياق الثارات المتراكمة والمتراكبة. ماذا يعني لشخص فقد عينيه في المجزرة أن تنتج له فيلماً يتقاسم شخصية البطل فيه رواندي من الهوتسو والآخر من التوتسي. أو أن يبدأ المسؤول خطاباً رسمياً بتحية احترام وإكبار لضحايا المجزرة! كل ذلك دون القيام بأي فعل جمعي لرأب الصدع وشفاء ما في الصدور. بعيداً عن سذاجة الكلمات، شرعت رواندا بمحاكمات واسعة شملت كل من طالت يده دماء الآخرين وأعراضهم، عرفت باسم محاكم غاشاشا،، وأنشأت لجان الوحده والمصالحة؛ التي عكفت على تيسير حوارات بين مكونات المجتمع في كل انحاء البلاد، وخلقت هوية روندية جديدة بعيدة عن الانقاسم العرقي. ولكي تضمن أن تظل ذاكرة الأجيال حذرة من الانجراف مرة أخرى وراء العنف والانقسامات الإثنية شيدت شواهد بارزة في التجمعات السكانية، أهمها نصب كيغالي التذكاري، من الأجدر أن نقول النصب التعليمي أيضاً.
ثم تنظر إلى جريمة الأجيال المسروقة في أستراليا وتتساءل، هل دمل الجرح حقاً؟ على أهمية اللحظة المؤثرة للعديدين عند الاعتذار الوطني عام 2008، إلا أن العديد من الأستراليين الأصليين والسكان الأصليين لجزر مضيق توريس، شعروا أن الاعتذار اللحظي لم يرتقي لألم مائة عام من نزع الأطفال من أحضان أسرهم تحت غطاء القانون! لازالت تركة الأجيال المؤلمة تتناقل بصمت من جيل إلى جيل. وحال السكان الأصليين الأستراليين لا يختلف كثيراً عن أشقائهم في الألم من سكان أمريكا الشمالية الذين تعرفون قصص تهجيرهم وإبادتهم البشعة، ومحاولات تجريدهم من هويتهم ولغتهم وإرثهم. فلم تقدم أي الحكومتين الأسترالية والأمريكية تعويضات حقيقة مباشرة لأفراد القبائل المتضررة، المنكوبة عبر قرنٍ أو يزيد. تأمين صحي عام يساوي صاحب الأرض الأصلية بالسارق، ومدارس لا تعلم لغتهم ولا تقاليدهم إلا بالحد الأدنى، وأنى لهم استحضار تاريخهم وإرثهم وكل ما يملكون من آثار أجدادهم أحاديث الكبار الناجين!
إن الصوابية السياسية مفهوم متعدد الجوانب وقابل للتطور، متجذر بعمق في الخطاب الفلسفي للأخلاق واللغة، يكتسب قيمته عندما ينطلق من الصدق ويترجم على جوارح الأفراد وفي سياسات المؤسسات. لن تحقق الكلمات هدفها في التوافق ومعايير الصوابية السياسية في المجتمعات المعقدة المتراكبة، الحاملة أرث التركات من الصدمات الجيلية، إذا لم تكن نية الإدماج صادقة ومتجذرة في كيان الأمة ووعيها، وتعكس فهماً عميقاً وأصيلاً لقيم التنوع والتضامن الإنساني، الصدق هنا يعني الاعتراف بالخطأ وجبر الضرر والتعلم من التجارب والسعي لتطوير السلوك وتعميق المفاهيم الدامجة للآخر. الصوابية السياسية كأي لغة، قادرة على الجمع والفصل في آن معاً، واللغة التي لا تستند للصدق مدعاة للإهمال والإسقاط.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.