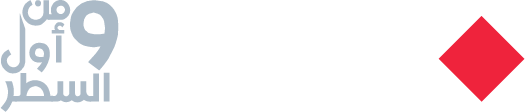إقرأ أيضاً

دفعتني صور الدفعة الرابعة من الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس ضمن ترتيبات صفقة التبادل إلى مأزق أخلاقي عنيد.
مراهقين، تمتد لهما يدٌ لمقنع حمساوي بزجاجتي مياه، تستدعي صورة الرجل الفلسطيني الكهل الذي أقعى على الأسفلت يحاول أن يلملم بصورة يائسة و(سيزيفية) الماء المتسرب على الرصيف، الفلسطينيات اللاتي ذهبن للشرب من ماء البحر!
مراهقة أخرى، تحمل في يدها اليمنى عصيراً وبعض البسكويت والشيكولاته، جعلتني أستدعي يوسف الحلو صاحب الشعر الكيرلي، وجوليا الذاهلة لفقد والديها، والصرخة الثكلى، هاي روح الروح، التي تدوي في داخلي كلما احتضنت طفلتي الصغيرة، روح روحي، أنا المحظوظ الذي كتبت لي الحياة بعيداً بعض الشيء عن آلة قتل وحشية نهمة، وغير أخلاقية بالضرورة.
ما الذي كنت أريده؟
المأزق الأخلاقي يتبدى في قناعة متجذرة بأن الإنسان، لمجرد كونه إنساناً لا يجب أن يصفع على وجهه، فكيف يمكن أن أقبل بالتعذيب أو تقطيع الأوصال.
في فقه السنة، يتحدث سيد سابق، عن تحريم صفع الوجه الإنساني بالمطلق قياساً بحديث يحرم ضرب الدابة على وجهها ليسحبه على الإنسان، كان فقه السنة كتابي المفضل في فترة التدين في مطالع المراهقة، أما كيف أصبحت شيوعياً لفترة من حياتي، فاللأمر مرتبط بمشهد صغير رأيته وأن أركل ورائي صخب مراهقتي المتعبة، ففي صباح سكندري مبكر، وجدت تلك الفتاة التي تنقب في أكوام المهملات (الزبالة) وتستخرج من رأس بصل قطعته سيدة ما لتعد وجبة لأسرتها، ما تبقى من طبقات البصل، وتنتقل من رأس إلى أخرى، يالله، مشهد واحد دفعني لحالة من الزهد والقرف لفترة من حياتي، فكيف يمكن أن يتحمل ملايين الأطفال والمراهقين الذين يتابعون أحوال (أهوال، ولو بدت قديمة فهي الأدق في الوصف) أهل غزة؟
لنتفق على شيء، الأصل أن يخرج الأسرى واقفين على أقدامهم، من غير خدش واحد، ولكن شيء عميق في غريزتي يجعلني لا أحب صورتهم اللامعة لأنها تجعلني أقارنهم بأسرانا الذين خرجوا من السجون، ومعظمهم، وخاصة الأطفال والمراهقين، كانت أقدامهم ثقيلة وعيونهم فارغة وأرواحهم مرهقة.
بتاخد الدوا يا يابا؟ هكذا يخاطب والد الأسير الطفل أحمد المناصرة ابنه الذي تعرض لمحنة السجن وأخضع لعملية ممنهجة لنزع إنسانيته، وشاهدناه يغرق في مرضه النفسي من غير أن نفعل شيئاً، يمكن أن تتوقفوا عن القراءة وتذهبوا إلى أرشيف اليوتيوب، كل ما ستحتاجونه هو كتابة أحمد المناصرة في خانة البحث.
لدي هواية صغيرة وطفولية، ربما بقيت منذ أحلامي الطفولية الساذجة بأن أصبح مخرجاً سينمائياً، يوسف شاهين كان دافعي الأساسي عندما شاهدت فيلمه (إسكندرية كمان وكمان) في الثالثة عشر من عمري، أتخيل الناس في أدوار سينمائية، أناس أعرفهم وآخرون أشاهدهم على الشاشات، جمال عبد الناصر، مديراً لمدرسة ثانوية، وأنور السادات موظفاً فاسداً في دائرة جمركية، هل فهمتم الهواية أو اللعبة؟ جولدا مائير لا تفارق الساحرة التي تنغص حياة الأميرات البريئات، تلك التي تهبط بمكنستها على حياة الآخرين لتدميرها من غير مقدمات معقولة أو مقبولة، مائير ليست شخصية درامية، هي فانتازيا خاصة لتطرفها في تلبس الشر والوحشية والانتقام وعبادتها للفوضى في جميع وجوهها، وبين كل ترهاتها وأكاذيبها الثقيلة، أتت الأكذوبة الفاجرة: يمكن أن نسامح العرب على قتل أطفالنا، ولكن لن نسامحهم على دفعنا لقتل أطفالهم.
إبليس نفسه يبدو متواضعاً في مغالطاته أمامها، ومفهوماً على الأقل في البعض منها، ولكن يبدو أن السيدة الشمطاء لا تفهم معنى الحياة في البداية وتقفز إلى الموت بوصفه مملكتها المفضلة.
لقد قتلوا أطفالنا وألحقوا العجز الجسدي بكثير منهم، وفتحوا بوابات جحيمية في أقاصي اللا وعي داخلهم ستنفتح يوماً بصورة لا يمكن لأحد أن يتنبأ بشكلها أو يقدر حدودها.
الحياة الزائفة التي يعيشها المستوطن تبدت أمام تجربة الحياة في الأسر في غزة ولذلك خرج الأسرى الإسرائيليون أكثر حياةً وبعيون لامعة، أما الموت التدريجي الذي يعايشه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال فأخذ يظهر أمام الجميع في العيون المطفأة التي حملوها إلى العالم وصدمة الحرية التي تثقلهم.
عندما تفترق المفاهيم حول الحياة والموت، يصبح الحديث عن الأخلاق ترفاً، ومع ذلك، فثمة شيء سيترك ندبة أخلاقية لدى الجميع بعد هذه الحرب.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.