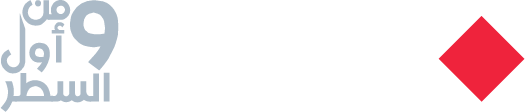إقرأ أيضاً

استنجدت ليلة أمس بالشرطه لوضع حد لمقاول متنفذ، يعتقد أنه فوق القانون فلا يحلو له أن يبدأ في أعمال الإنشاءات المزعجة تحت شباك بيتي إلا بعد منتصف الليل. وبالفعل بعد دقائق اتصل معي شرطي مهذب وطلب مني كل التفاصيل، وسرعان ما خَفَتَ ضجيج العمال، وتوقف هدير الشاحنة وخرست كل الأصوات الخارجة عن المألوف وعم السكون من جديد في حيِّنا. لم أر وجه محدثي المقدام الذي أنقذ ليلتي من أرق غير مبرر، لكن في مخيلتي لم يكن يركب الفورد اكسبولرر يزينها اللواح، بل خيلاً من الموريات قدحاً، يشهر سيف صلاح الدين ويقتص من المعتدي على راحة الآمنين. تتطابق هذه الصورة إلى حد كبير مع رؤيتي للشرطي في طفولتي، هو الشخص الوحيد الذي علي أن أتوجه إليه إذا أفلتت يد أمي وضعت في زحام السوق، وهو الذي سينقذني إذا احترق المكان، وهو الذي سيمسك اللص.
في ذات الوقت الذي كان الرقيب المحترم ينقذني، كان زميل له في قوى الدرك يهوي بهراوة قاسية على ساق شاب يتظاهر غضباً لما يحدث في غزة في منطقة الرابية قرب سفارة الكيان الصهيوني. لا أتخيل أن أكون من سكان منطقة الرابية في هذا الوقت، ولا في أي وقت في الواقع، فما أكثر التظاهرات التي تصل إلى أبواب كل مبنى في الرابية، إلا مبنى السفارة. ما أهون إزعاج المقاول الجشع مقارنة بضجيج الرابية في هذه الأيام؛ آلاف المتظاهرين، رائحة الغاز المسيل للدموع، الإغلاقات المترتبة على حصار السفارة البغيضة كلها أصبحت أكثر كثافة منذ أحداث السابع من أكتوبر. يشعر أصدقائي القاطنون في الحي، أن السفارة نتوء بشع في وسط تلِّتِهم الخضراء الوادعة أنيقة المنازل. لا أعرف شكل السفارة التي اختارت مكاناً لها في وسط هذا الحي السكني، ولا أدري ما هو المسوغ لاختيار الموقع. لا أعرف كذلك متى افتتحت السفارة أصلاً، ربما في أواسط التسعينات بعد توقيع اتفاقية السلام مع الكيان اللاسلمي. لكنني أذكر أنها أغلقت عدة مرات، عام 2011، وفي عام 2017 بعد أن قتل أحد الدبلوماسيين أردنيَّين، شاءت الرمزية أن يكون أحدهما من الضفة الشرقية والآخر من الغربية لنهر الأردن. وهي الآن مغلقة لغياب سفيرها قسراً بأمرٍ أردني مشرّف، مدروس بعناية.
أعود إلى الشاب الذي يسقط تحت الهراوة. تدرب الدركي على اختيار موضع الضربة بعناية، يجب أن تسقط الشاب أرضاً دون أن تسبب له كسراً في العظم، لا بأس بقليل من الرضوض والكشوط، فهي تشحذ همة الدركي وتقي نفسه هواجس الأسئلة التي لا داعي لها. لا أحد يعرف ما الذي يحدث في المظاهرة، لا الدركي يعرف، ولا المتظاهر يعرف، هناك مسؤول في مكان ما، يرى ويسمع كل شيء. يقرر أن الهتاف أصبح مقلقاً، أو أن الشباب بدأت تزحف في اتجاه محرم، أو أن ساعة معينة قد حانت (غالباً ما تكون ساعة معقولة لينام السكان)؛ فيطلق التحذير الأول والثاني والثالث، وربما أكثر قبل أن يفتح القوة الضاربة، التي في وسط هذا البحر من البشر، لا تضيع الكثير من الوقت في البحث عن موضع الضربة، “وين ما اجت تيجي”، المهم أن ينفّذ الأمر وتحقق الغاية، ويعود الدركي بأسرع وقت إلى بيته المتعب، وأقساط سيارته المتعبة، وأيامه المتعَبَة المتعِبة، ويجر المتظاهر المتعب إلى بيته أو إلى بيت خالته، حسب مقتضى الحال.
تقول الدولة أن جهات خارجية تحرض المحتجين، ويقول المحتجون أن دماءهم ودماء أخوتهم على الجهة الأخرى من النهر تنبض من قلب واحد. تقول الدولة أنها فعلت وتفعل كل ما بوسعها لتوقف شلال الدم النازف في فلسطين، ويقول المحتجون أن الدولة لا تقوم بما يكفي لكبح جماح آلة القتل الممنهج على حافة البحر ولا في الضفة القريبة. تقول الدولة أن المحتجين مخربون، ويقول المحتجون أن الدولة ظالمة معتدية. لا أحد يعرف ماذا يحدث في المظاهرة، لأن الجميع على حق، والجميع يائس مستنفذ الأدوات. الدركي يريد أن يعود إلى بيته المتعب، الساكن يريد أن يهنأ بليلة هادئة، المحتج يريد أن يفعل أي شيء ليبرد غليان الدم في عروقه، ويصلح الكسر في قلبه وفي كرامته، الغزي يريد أن تصل من تحت الأنقاض صرخته إلى أطراف الكرة الأرضية، وسياسيّ يريد أن يضغط بأدواته التي استعادت ألقها باحثاً عن لحظة مواتية، لفتح أفقٍ سياسيٍ ما. لا أحد يعرف ماذا يحدث في المظاهرة، لكن الجميع يعلم أن أردنّــاً ممزقاً لا يحمي فلسطين… فرفقاً به.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.