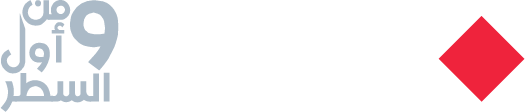إقرأ أيضاً

كلما تنقلت في قائمة الأغاني الأثيرة التي تناسب المناخ الإقليمي وتحترم الموت المخيم، أجدني أعود إليها. لا أعرف بدقة ماذا أراد أحمد فؤاد نجم بعيون الكلام، ولا أعرف لماذا اختار الشيخ إمام ذلك اللحن الجنائزي الرصين، ولا أعرف لماذا أعود إليها.
“أشعر بالذنب مع أنني لم أفعل شيئاً!”، قالت صديقتي بينما تجمدت دمعة في وسط عينها اليمنى. لا أملك سوى حضني لأهبه لصديقتي الرقيقة، التي تتألم عندما تضع طفليها في الفراش بعد حمام دافئ ووجبة مشبعة، مدركة أنهما سيستغرقان في النوم بسلام ويبحران في أحلام هادئة تبني قدراتهما العقلية، ويستيقظان بفرح في انتظار يوم جديد. بينما في قريبنا الجغرافي والروحي أطفال ينامون مستحمين بدمائهم، ولا يستيقظون أبداً. لا أملك سوى حضني لأهبه لصديقتي ولكل من يسيرون حولي كالأشباح، أجساد بلا روح، عيون يحيطها السواد من كثرة البكاء وقلة النوم، والتحديق المتواصل في شاشات الهاتف والتلفاز، متابعة قنوات تيليغرام، وبكرات من الفيديوهات المتواصلة على حوائط البيوت الافتراضية في فيسبوك وانستاغرام. لا أملك سوى حضني لأهبه لجارتي، التي تتصل يومياً عشرات المرات مع أهلها في غزة، تسأل عن كل الجيران واحداً واحداً، وعن قطتهم، وعن صاحب الدكان المجاور، وتسمي كل الشوارع والحارات، وتبكي إلى أن ينهرها أهلها القابعون تحت القصف أن “تشد حالها”، مؤكدين أن كل شيء على ما يرام، والوضع “آيس كوفي”.
لا أملك الكثير لأعطي من حولي، أدعوهم لاستجماع القوة، وأسوق في سبيل ذلك كل ما حفظته من مقتطفات من حديث خبراء التنمية الذاتية، وعلماء الطاقة وما حفظت من المأثورات والأحاديث النبوية ومقولات بوذا والإمام الشافعي إلخ إلخ إلخ… وأعلم أنها لا تجدي نفعاً مع شعور قلة الحيلة… “حاس حالي مربط…” جملة تكررت على مسامعي خلال ثلاثة أسابيع من الجحيم عاشها أهل غزة، والضفة الغربية، وعاشها أيضاً بشكل أو بآخر نصف مليار عربي وملايين من المناصرين في العالم. “مربطين”، نعم، هذا ما يشعره كل من يشاهد ما تجود به شاشات الهواتف التي تنقل بالصوت والصورة، بألوان واضحة، صوت الهواء، صوت الصاروخ الذي يسقط، الردم الذي يزال والأرواح التي تصعد… كله يصل إلينا بوضوح. قد لا نشم رائحة الموت عبر شاشة الهاتف، ولا تلفح وجوهنا حرارة التفجير التي تصل مع الهواء المندفع من منطقة سقوط القذائف، لكننا لا نحتاجها لنشعر بألم في البطن، ووخز في القلب و”تربيط” في اليدين. نعم، القابعون تحت الركام “مربطون” ومكممون، ومدفونون، وربما كان ما يصلنا هو امتداد لما يشعر به إولئك الموؤودون بلا ذنب. أذكر بوضوح دموع أمي خلال مجزرة صبرا وشاتيلا، مع أنني كنت صغيرة، وشاشة التلفاز كانت صغيرة جداً، وجودة التصوير متدنية للغاية، لكنها كانت تبكي، كانت ترى التفاصيل في الصورة، حتى تلك التفاصيل التي لم تلتقطها عدسة الصحفي، ربما للقلب عين وأذن.
على متابعتي الحثيثة لكل تطور في الأوضاع في غزة والضفة لحظةً بلحظة، إلا أنني في محاولة لتحصين ذاتي نفسياً، أتعمد أن أتخطى التغطيات الدموية للأحداث، ليس تقليلاً من ألم الجرحى وخسارات الشهداء، ولا استخفافاً بتضحياتهم وتضحيات أسرهم، لكنني أحتاج أن أحتفظ ببعض القوة لأواجه كل الذين يعتمدون علي، ولا أجد أن متابعتي ستقدم أو تؤخر شيئاً. لكنني أتعمد عن سبق اصرار وترصد أن أتابع، وأبحث بجد عن كل ما يصور المنعة الغزية الأسطورية، فيديوهات لأطفال يضحكون من تحت الأنقاض، لأطفال يتسابقون للوقوف أمام كاميرا صحفي يلاعبهم في ساحة مدرسة الأونروا التي اتخذوها وأهلوهم بيتاً، فيديو لطبيب أو متطوع غزي، يلاعب طفلاً رضيعاً بضحكة باتساع غزة وجمال شاطئها الذي أشتهي، صورة لامرأة تخبز للأسرة وللحي وفي الخلفية بيتها مسطحاً، صورة لحلاق شاب يشذب الشعر الشائب لرجل متوسط العمر ويقول له “نعيماً!” وكلاهما يبتسم بفرح لأن هذه الحلاقة انتصار صغير في يوم ربما لن يرو غروبه. أبحث بجد عن تلك الفرحة وسط الأنقاض، كما كان يبحث ذلك الولد الذي نجى للتو من قنبلة شرسة تذيب الأطراف عن قطته ووجدها، وتلك الصغيرة عن كتاب الحساب، أحفظها جميعاً على ذاكرة الهاتف، لآخذ جرعة مركزة منها بعد كل نشرة أخبار، أو بعد سماع تصريحات “قواد العالم”… عفواً “قادة العالم”، يالبذاءتي! أبحث أبعد من غزة أيضاً، أبحث في فضاء إنساني واسع عمّن يشبهنا، عن صورة لشوارع العواصم الباردة التي زرت، وهي دافئةٌ بأنفاس مئات الألوف من المتظاهرين. يسعدني تسجيل لفتاة أوروبية تتحدث عن انفجار الألم الفلسطيني المتراكم عقوداً. آخر لفتاة يهودية أمريكية من أحفاد الناجين من المحرقة البشعة، بملامح تشبه ملامح ابنتي، تصيح ملء رئتيها: ليس باسمي! وهي تنزع عن مظلومية جدِّها ما علَّقته آلة القتل البشعة من مظلوميات عربية. عن مؤرخين، ومهتمين، ومكلومين، وعن شاب يؤمن أن المحتوى الذي يقدمه العديدون على تيك توك أثار فيه أسئلة أعمق وأقسى من كل كتب التاريخ التي جرعته إياها أنظمة التعليم في بلاده الشقراء.
يؤمن البعض بأن الكون طاقة، وأن الدورة الدموية أو الحيوية لهذا الكوكب هي هذا التبادل الطاقي، يؤمنون كذلك أن الموت انتقال لطاقة ما إلى مرحلة مختلفة، وهذا معتقد يشترك فيه -مع فروقات في الشكل- معظم المؤمنين، كتابيين وغير كتابيين وربما قليل من اللاأدريين. لعلها رغبة الإنسان بأن يعزي نفسه بأن هناك مكان أفضل من هذا العالم. بكل الأحوال، لكل منا مذهبه في ايجاد الرواية التي تزيل عنه ألم الخسارات التي تعنيه، أو التي يشهدها. إن الشيء الوحيد الذي نستطيع فعله معشر المربَّطين لفك الوثاق؛ هو البحث عن طاقة الأمل وسط الموت، أن نركز على الزهرة التي نجت من الحطام، وعلى ابتسامة سكان المدرسة الصغار، وقوة الرجل الذي فقد أطفاله في الليل، وعندما أشرقت الشمس اغتسل بنورها وما تيسّر من الماء المتاح، ووضع خوذته وسترته الزرقاء الواقية من كل شيء؛ إلا من ألم الوداع الأخير، ثم وقف أمام الكاميرا لينقل الخبر. أن تفعل شيئاً، أفضل من الاستسلام للوثاق الذي يضغط على أنفاسك أكثر كلما سمعت أنين طفل، أن تفعل أي شيء أفضل من اللاشيء، لأن الفعل طاقة، والطاقة حياة ستنتقل بطريقة أو بأخرى، منك أو من فتاة أوروبية ترتدي الكوفية السوداء، إلى أم غزية تخبز للأسرة والحي، وإلى طفل يضحك للكاميرا. ربما كان هذا هو الدليل الذي سيجده أبو المفهومية في عيون الكلام.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.