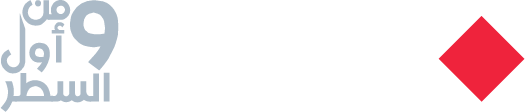إقرأ أيضاً

من المعروف أن الناس صدقوا في الماضي بأن من يقرأ ألف ليلة وليلة، يلقى الهلاك، وكان هذا دافعًا كافيًا ليؤمن الجميع بهذه الأسطورة، وقد ورد بتحقيق السير ج إم موريس، عن بعض المخطوطات في القرن السادس عشر في الشام والقاهرة العثمانية، أن هناك مجموعة تكونت لهذا الهدف وحده. كانوا مجموعة من طلبة الأزهر المُجدين، وردوا إلى المسجد من مختلف البقاع داخل مصر، وواحد منهم فقط كان مغربيًا من فاس، وهو وقود هذه المجموعة، بما عُرف عن المغاربة من الحسم في المسائل الدينية ودرايتهم بالعلوم الشرعية، وكان الشاب الذي اسمه إدريس الوزان، مع زملاءه، والذين لا نعرف من أسمائهم سوى اسم كنية وهي أبو محمد البحيري، ما أتوقع أنه من البحيرة، الوقود الكافي لتحدي هذه الأسطورة، والتي وصلت إلى مداها الأوسع حينها، خاصة مع انتشار الكتاب بين الطوائف العليا بالدولة، وبعض السادة الأشراف والتجار، وكانت الفكرة تتركز حول مقاومة أسطورة أن من أنهى الكتاب سيموت أو يلاقي حتفه، لأنها تضع للكتاب قوة شبه إلهية، وتعطيه قداسة ليست فيه، خاصًة مع انتشار القصص الجنسية الخليعة، حول خيانات وعلاقات حب بدون رباط شرعي، وكان من الأجدر، حسب مناقشات هذه المجموعة، أن يكون القرآن الأكثر جدارة بالتقديس، ولأن هناك أطروحة جعلت كتاب ألف ليلة وليلة ابنًا للشيطان، صار مثل كتاب حكايا مضاد بسفالته لقصص القرآن، وخاصًة قصة سيدنا يوسف التي تنهى عن الزنا وتصور المقاومة الروحية في أسمى صورها. لم يكن هناك حل سوى اتفاق بينهم، ينص كتابًة على أن يقرأوا جميعًا كتاب ألف ليلة وليلة، حتى نهايته، بوقت يحددوه، على أن يعلنوا ذلك على الملأ من باقي الطلبة والسادة المشايخ المعلمين، وصولاً بعدها عن طريق النقل والخبر إلى العموم والخصوص. حددوا الثلاث، رجب وشعبان ورمضان، لقراءة الكتاب بأكمله، وكان ذلك سهلاً، رغم غرابة التفكير فيه حاليًا، لأنهم كانوا من أزمنة القراءة والكتابة بلا كلل، حتى أنني أتصورهم ناحلين بثياب فقيرة، وذوي مظهر مخذول. كانوا عشرة طلاب علم، بدأوا القراءة فعلاً، وكونوا مع ذلك ما يشبه أخوية بالزمن الحديث، تنص على انهاء الكتاب، وتدارسه فيما بينهم، ثم اعلان ضعفه الانساني العام، وكيد الشيطان، مستندين إلى آية الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76) من سورة النساء. في ليلة القراءة الأولى، قرأوا البقرة كاملة، مع قصار السور، والمعوذتين، وبدأت القراءة في جماعات أو فردية بحتة، على أن ينتهوا في رمضان. لم ينتهوا بحلول عيد الفطر، وكان ذلك بسبب الانشغال الطبيعي بالعبادة في رمضان نفسه، ووجود حلقات علم ضرورية، فغيروا الخطة، وحددوا النهاية برمضان العام التالي، وعينوا إدريس الوزان شيخًا لهم، ومشرف جاد على نهاية القراءة. ما دونه السير ج إم موريس، استنادًا لعدة أبحاث، أن هذه المجموعة لم تنتهي أبدًا من قراءة الكتاب بصورة طبيعية، فثلاث من المجموعة(الأخوية) تخلوا عن القراءة مع الضلالات الجنسية التي صارت تلعب في بالهم، خاصًة وأن الخيال حينها كان بكرًا، بعيدًا عن زمننا المتخم بالصور، بينما وقع اثنين في متاهة الكتاب، وشعروا أنها من مكائد الشيطان الحقيقية، واستندوا إلى فتاوى البعض التي تؤكد أن ذلك من صور تلبيس إبليس؛ لأنه صور لهم مهمة قراءة الكتاب كمهمة مقدسة، يمكن معها أن ينتصروا فيها عليه، ولكنهم شغلهم في وقت الحياة الثمين هذا عن تدارس القرآن الذي هو بحر لا يفنى، وكانوا أول من انفصل عن الأخوية، بكل احترام، ولم يبقى سوى خمس، منهم إدريس الوزان، قضوا نصف عام في المهمة، وعند اقتراب رياح الصيف المغبرة، حدث خلاف بينهم، لأن أحد بكوات المماليك سمع بمهمتهم هذه عن طريق عين أمينة، من العيون التي تنتشر في الأزهر، فعرض عليهم مقابل مادي جيد، مقابل الانتهاء السريع، مع رعايته الكاملة لهم، حتى أنه أوقف لهم بعض غرف بيته الجميل على بحيرة الأزبكية، ووعدهم بالاعلان الرسمي عند الوالي العثماني نفسه، ذاكرًا أن خليفة المسلمين في استنبول، السلطان سليمان القانوني، يكره الكتب الضالة، ويتابع أمورها باهتمام، مع تركيزه على حركة دراسة كتب الفقه والمذاهب. كان الخلاف متوقعًا، وحدث في يوم نحس، لأن بعضهم مس شرف تناول مشروب الخوخ المجفف، وعصيدة ملتزمة وحلوة، وتناول اللحم بالبرقوق، وهي كلها أكلات لم يسمعوا عنها في عالم من الفول النابت، ولأن إدريس الوزان، ورفيق ثاني مجهول الاسم، قاوموا فكرة تدخل المماليك في الأمر، باعتبار أنهم فاسدين، مع ضياع مهابة العلم بهذا العمل، قال إدريس الوزان بوضوح:
-لا نعمل سوى عند الله ومشايخنا.
كان حالة ميئوس منها من مثالية حقيقية، وانفصل ثلاث عن المجموعة، وأعطوا أنفسهم للبك المملوكي، الذي كان ينتمي لسلالة خاصة من مماليك قايتباي القديم، تزوجوا بأولاد البلد، واشتهر ببناء الزوايا والخنقاوات، فأجرى عليهم المال والوقت والمكان لانهاء القراءة، ولكنهم فشلوا بسبب الوهن الذي دب في أجسادهم مع حياة الدعة، والخوف الطبيعي من المسائلة، لأن مماليك البك كانوا يتابعون سير الأمور يوميًا، فاعتذر اثنين منهم عن المهمة، وبقي واحد طموح، ظل يقرأ يوميًا، حتى أجرى له البك المملوكي اختبار سريع، فسأله عن آخر حكايات السندباد البحري في قصصه، فخلط بين حكاية الرجل العظيم الذي يأكل الناس، وبين حكاية طائر الرُخ وزوجته، ثم أعلن أسفه باكيًا، فقال البك المملوك ببال مرتاح:
-لا عليك، سأعينك كاتبًا، ولتنىس قصة هذا الكتاب الشؤم.
وقد سعى هذا البك في مواجهة نسخ الكتاب وبيعه، وترديده في المقاهي، بدون جدوى، خاصًة مع تراخي سلطة القلعة في مواجهة الأمر، وكان حظ صاحبنا جيدًا لأنه كان رجل طيب، يحب الروح ويجلها، وينفر من الدماء، لذلك عاش في كنفه وانقطع خبره بعدها. في الوقت نفسه، من المؤكد، أن إدريس الوزان، عندما كاد ينتهي من الكتاب، مع رفيقه الثاني الصامد، اكتشف أنه قد وقع في حبه بصورة أو بأخرى، وأن قراءته للنصف الثاني من الكتاب الذي لا ينتهي لا تشبه قراءة النصف الأول: فقد كان ينتظر نهاية القصة بصبر، ويسبح الله ويستغفره عند نهاية القصص، تضامنًا مع الأبطال، ولذلك، عندما نجح فعلاً في قراءة الكتاب كله، واجتمع برفيقه الذي أنهى الكتاب نفسه، كان مضطرًبا بالشكل الكافي ليناقض سبب بداية الأخوية، التي أنشأها بنفسه، فتحدث خجلاً عن قصص رآها يمكن أن توضع بموضع العظة، خاصًة قصة مدينة النحاس والتي عثرت عليها حملة سيرها عبدالملك بن مروان بحثًا عن قماقم جان النبي سليمان، والمدفونة في بحر ما، مع قصص أخرى، وأنه يقترح القبول بالكتاب لو أزيلت منه الحواشي الجنسية السيئة، ولأنه كان مسحورًا بالكتاب فعلاً، ويشعر بأنه قد حاز علمًا حقيقيًا بأسطورة حية، وأكمل ما لم يكمله أي أحد خلال قرون، خلع الخجل مقابل حماسة مقدسة، اهتز لها وهو يحكي عن عظات الكتاب ومثالبه، والنسخة التي يزمع على نسخها بدون القصص الحمراء، ليكون كتاب حكايا جدير بالتأمل، ومن الواضح أن زميله الثاني لم يعجبه الكلام، أو صُدم في شيخ الأخوية المتآكلة هذه، فقابله برفض تام، وقال أن الحكايات ما هي إلا لحرق الوقت فعلاً، وأنها تنويعات بلا داع على قصص كتاب الله، وأن الأفكار التي تنبت في ذهن القاريء تجعله يؤمن مثلاً أن قاتلاً مثل السندباد، قتل كل أحياء كهف الموتى الذين يدخلونهم مع موتاهم، حتى يموتوا معهم، وسرق حليهم، يتحدث عن رحمة الله، تهاون مخيف في جرم القتل الذي قال عنه الله ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ من سورة النساء، لأنه عاش وحكى حكايته، وعدد مظاهر التشوه الذي سيصم الناس، ودخل معه ادريس الوزان في جدل حقيقي، حول وصم الكتاب بالكفر والضلال، فقال أنه كتاب ضال يمكن هدايته، وقال الثاني أنه كتاب كفر صريح، ولعله منسوخ بالعربية من أساطير عبدة النار والهنود، ونسيا في غمرة هذا أنهم أنهوا الكتاب كما اتفقوا في البداية، ودحضوا الأسطورة.
لا أعرف كيف تطور الأمر إلى ما وصل إليه، ولكن السير ج إم موريس أكد أن إدريس الوزان هذا قد قُتل على يد رفيقه المجهول، ويمكن أن أتخيل أن ذلك عقب مشاحنات قوية، وصدمة الرفيق في رفيقه شيخ المجموعة، ولم تعرف القصة كلها، سوى عندما اعترف رفيقه بالقتل في الجامع الأزهر، لدي شيخهما، والذي أبدى أسفه على الفكرة كلها من البداية، ورآها من أبواب ضلال السعي في الدنيا، وسجُن الرفيق الثاني حتمًا، ولعله أعُدم، وما يثيرني هنا، أن الكتاب نفسه، قد أثار فكرة القتل والنجاة هذه في قصة السندباد لدي الرفيق الثاني، ولعلها استبدت به، حتى قتل رفيقه، ولذلك كان يردد بثقة، وهو في المحبس، أو داخل الجامع عندما اعترف:
-جربنا بفضل الله، وهو كتاب ملعون فعلاً.
وتنتهي بهذا قصتهم، التي وردت مع قصة جماعة أخرى اسمها جماعة عبدالله الأسود، كانت تضمر حرق كل نسخ الكتاب قبلها بقرون، بدون فائدة.
الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال تعبر عن كتّاب المقالات، ولا تعبر بالضرورة عن آراء الموقع وإدارته.